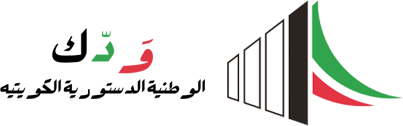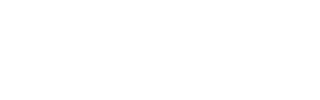في جمهورية فايمار، في السنوات الأولى من القرن العشرين، وبعد خسارة ألمانيا للحرب العالمية الأولى (1914–1918)، ومع تفشي البطالة والتضخم وتنامي الشعور الشعبي بالمرارة إزاء الهزيمة واقتطاع أجزاء من الإمبراطورية الألمانية، وجد اليمين المتطرف النازي فرصته التاريخية لإقصاء الديمقراطية عبر أدواتها نفسها.
فقد أقدم أتباع هتلر على إحراق مبنى البرلمان (الرايخستاغ)، ولم تمضِ سوى شهرين على فوز الحزب النازي في انتخابات ديمقراطية نزيهة، حتى وُجّهت أصابع الاتهام نحو الاشتراكيين، لتُتخذ الحادثة ذريعة للانقضاض على النظام، وتمرير ما بات يُعرف بـ”دستور هتلر”، الذي منح الزعيم صلاحيات مطلقة باسم “الحفاظ على الهوية الألمانية”.
اعتُقل الآلاف في معسكرات سرّية، وصودرت أموال المعارضين، وقُتل كثير منهم، وصولًا إلى انقلاب رسمي جرى شرعنته عبر استفتاء شعبي، لتتحول ألمانيا إلى دولة الحزب الواحد، والفرد الواحد، والدكتاتور الواحد.
وكما يقول العرب: “ما أشبه الليلة بالبارحة”. فالدستور الذي تجهّزه السلطة اليوم وتروّج له أبواقها — وعلى رأسهم المرتزق جاسم بودي — والمعروف بـ”دستور مشعل”، لا يختلف في جوهره عن دستور هتلر. تشابه حتى في تسلسل الأحداث، مع فارق في التفاصيل؛ إذ لم تستطع السلطة اصطناع حريق أو اغتيال، لافتقار البيئة الكويتية لمثل هذه الظواهر.
أقصى ما شهدناه كان حادثة “الدبّين والربعي” وبعض القنابل الصوتية، التي زُرعت مع إرهاصات تزوير انتخابات مجلس 1967 والتضييق على الصحافة، تزامنًا مع زيارة الشاه، الذي كان يُرى آنذاك، في أعين الماركسيين والقوميين الكويتيين — كأحمد الخطيب، وعبدالله النيباري، وأحمد الديين، وناصر الغانم — رمزًا للتمدّد الإمبريالي الأمريكي.
نعم، تتشابه السياقات في تبرير الانقلاب على الديمقراطية، وتدشين الحكم الفردي والتمييز العرقي؛ لا فرق بين “الآرية الهتلرية” و”الآرية المشعلية”. الفارق أن هتلر احتاج سنوات لترويض القضاء الألماني، بينما الشيخ مشعل اكتفى بزيارة واحدة أرعبت القضاة، ووبّخهم على مناصبهم ومكتسباتهم، فاستسلموا من المحاولة الأولى.
وها هو القضاء اليوم يصدر أحكامًا مشددة على المعارضين، تُمرر عبر فهد يوسف وتُنفّذ بلا نقاش. حتى حكم أحمد الفهد — المنتظر صدوره في 20 مايو 2025 — طُبع وجهّز وأُبلغ القضاء بمضمونه سلفًا، وهو ذات الحكم الذي صدر بحق طلال الخالد!
“دستور مشعل” لا يردعه مجلس قضاء أعلى انتهازي، ولا محكمة دستورية يُفترض بها — في الدول الديمقراطية — أن تكون الحصن الأخير ضد انحراف السلطة، لا سيما التنفيذية.
وإذا رأى هذا الدستور النور، فلن يكون إلا إيذانًا بظلام دامس يبتلع ما تبقى من وهج الديمقراطية الآخذة في التآكل، يومًا بعد يوم، تحت ضربات السلطة وتصفيتها المنهجية للمعارضين، فردًا تلو الآخر، دون رادع.
ويبقى السؤال المشروع: من يضمن ألّا تنهار الدولة بالكامل في ظل هذه الرجعية المتفشية؟
نرى اليوم سحب جناسي المادة الثامنة، وتعديل الرواتب بقرارات فوقية، واعتقال شباب لمجرد عملهم في العملات الرقمية!
فمن الضامن؟ لا قضاء. لا أسرة حاكمة. لا مجتمع مدني.
الجميع “ماسك الأرض”، كما نقول بالعامية.
لم يبقَ بصيص أمل.
ولا عزاء… إلا بتكبير لدستور مشعل.