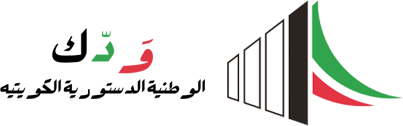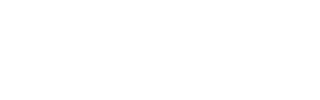الدستور ليس مجرد وثيقة قانونية؛ إنه تجسيد للهوية السياسية للدولة، ولعقدها الاجتماعي مع المواطنين. ومن ثم، فإن تعليق مواده، حتى لو كان تحت ذرائع مؤقتة، يُمثل شرخًا عميقًا في بنيان الدولة الحديثة. في الحالة الكويتية، جاء قرار تعليق بعض مواد دستور 1962 ليؤسس لمرحلة من اللايقين السياسي والفراغ المؤسسي، بما يتجاوز الظرف الذي برر به هذا التعليق.
الدستور كضمان لا كعقبة
منذ استقلال الكويت، شكّل الدستور قيدًا ضرورياً على السلطة التنفيذية، وملاذًا للمجتمع حين تتأزم السياسة. وبالرغم من أزمات متكررة بين السلطتين، ظل النص الدستوري صامدًا كمصدر وحيد للشرعية. لكن قرار الأمير في 10 مايو 2024، بتعليق عدد من مواده، يُمثّل اعترافًا ضمنيًا بأن الدستور لم يعد مُرضيًا للسلطة، لا أداة لحل الخلاف، بل عائق أمام مشروعها.
أزمة روحية لا إجرائية
الخطورة في القرار لا تكمن فقط في تعليقه المؤقت لبعض مواد الدستور، بل في ما يحمله من دلالة رمزية: أن النظام لم يعد يعترف بقيود النص ولا بمبدأ الفصل بين السلطات. إنها أزمة في روح الدولة، لا مجرد اضطراب مؤسساتي. فحين تصبح الدولة خالية من التمثيل الشعبي ومن الرقابة البرلمانية، فإن كل ما تبقى هو سلطة تنفيذية تتحدث باسم الجميع، دون أن يمثلها أحد.
سيادة الإرادة الفردية
تعليق الدستور رافقه خطاب سياسي يروج لفكرة أن الأمير وحده يملك “خطة الإنقاذ”، وأن العمل الجماعي والرقابة الشعبية عوائق أمام التنمية. وهذا الخطاب يعكس نقلة خطيرة من منطق الدولة إلى منطق الشخصنة، حيث تصبح السياسات العامة انعكاسًا لإرادة الفرد، لا نتيجة لتفاعل المؤسسات. هكذا تُستبدل الدولة القانونية بدولة الإدارة المطلقة.
بعد عام من هذا القرار، لا تزال الكويت بلا برلمان، وبلا أفق واضح لإعادة تفعيل الحياة الدستورية. لا نعيش فقط في مرحلة مؤقتة، بل في لحظة مفصلية يعاد فيها تعريف ما تعنيه الدولة والدستور والسلطة. وإذا ما استمرت القوى الحية في المجتمع على صمتها، فإن تعليق الدستور سيتحول من استثناء مؤقت إلى نقطة انكسار لا عودة منها.