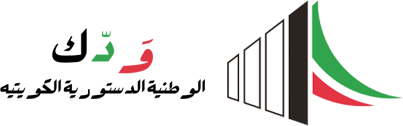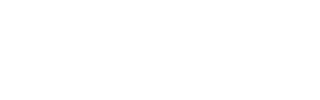منذ مطلع الألفية، تحوّلت الأزمات السياسية في الكويت من أحداث استثنائية إلى ظواهر متكررة، ومن تصدعات طارئة إلى ملامح دائمة للمشهد العام. ومع قرار 10 مايو 2024 بحل مجلس الأمة وتعليق بعض مواد الدستور، دخلت البلاد في طور جديد من “تطبيع الاستثناء”، لم يعد فيه تعطيل الديمقراطية صدمة، بل أمرًا متوقعًا، بل وحتى مقبولًا لدى شرائح من الرأي العام.
فقدان الحساسية تجاه المساس بالدستور
حين يُعلّق الدستور في أي دولة ديمقراطية، تُدوّي الأجراس في الصحف، وفي الجامعات، وفي الشوارع. أما في الكويت، فقد جاء القرار مصحوبًا بهدوء شعبي نسبي، وخطاب إعلامي مروّج له، وتصريحات نُخبوية متواطئة أو مترددة. وهذا لا يُعبّر عن رضا حقيقي، بل عن إنهاك تراكمي لدى المواطن الذي اعتاد رؤية المؤسسات تُحلّ، والدستور يُنتقص منه دون نتائج ملموسة.
المسؤولية النخبوية عن هذا التآلف
جزء كبير من تطبيع الأزمة يعود إلى موقف النخب السياسية والاقتصادية والثقافية، التي لم تُقدّم موقفًا أخلاقيًا صريحًا مما جرى، بل اكتفت إما بالتحليل التقني أو بالصمت. هذا التواطؤ الرمزي هو ما جعل القرار يمر كحدث إداري لا كزلزال سياسي، وأسّس لحالة من الانفصال بين الحدث الجسيم وردة الفعل المفترضة.
الإعلام كأداة لإنتاج القبول
أدت المؤسسات الإعلامية دورًا رئيسيًا في إنتاج نوع من القبول الرمزي بالقرار، من خلال شيطنة البرلمان، وتضخيم أخطاء النواب، وتقديم الأمير كـ”رجل دولة” يتخذ قرارات موجعة لكنها ضرورية. وهكذا، تحوّل الفعل الاستثنائي إلى حل عقلاني، وصار المساس بالدستور مشهدًا مكرّرًا بلا كلفة سياسية تُذكر.
تطبيع الأزمة لا يعني فقط قبولها، بل فقدان القدرة على تخيّل بديل لها. وبعد عام على قرار التعليق، بات الخطر الحقيقي هو في التعايش مع اللاشرعية، والتكيّف مع الحكم الفردي، والقبول بواقع استثنائي كأنه الأصل. وهنا تكمن المهمة الكبرى لأي قوى حية في المجتمع: إعادة الدستور إلى موقعه، لا فقط كنص قانوني، بل كحاجة جماعية وأفق تاريخي.