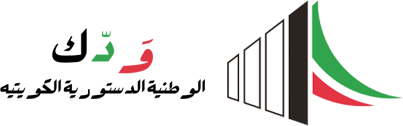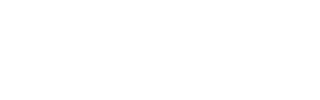منذ خطاب 10 مايو 2024، روّجت السلطة لما سمّته “خطة إصلاح شاملة” يقودها الأمير بنفسه، بعد تعليق بعض مواد الدستور وحل مجلس الأمة. ورغم مرور عام على هذا القرار، فإن ملامح الخطة لا تزال غامضة، وأدواتها غير ديمقراطية، وآليات محاسبتها معدومة. مما يطرح سؤالًا جادًا: هل نحن أمام عملية إصلاح فعلي، أم انقلاب ناعم على الدستور والمؤسسات؟
الوعود الإصلاحية دون أفق مؤسسي
خطة الأمير المعلنة تحدثت عن “إعادة بناء الدولة”، و”إصلاح العمل السياسي”، و”حماية المال العام”، وكلها أهداف يُفترض أن تجد صداها في برامج حكومية ومشاريع تشريعية. لكن المفارقة أن هذه الأهداف تُنفذ دون رقابة برلمانية، ولا شفافية إعلامية، ولا مشاركة مجتمعية. كيف يمكن أن يحدث إصلاح في غياب المؤسسات التي تضمنه وتقيّمه؟
الاستفراد بالسلطة بوصفه إصلاحًا
المفارقة الأكثر دلالة أن المشروع الإصلاحي ذاته أُطلق من خارج النظام الدستوري، أي من سلطة الأمير المطلقة بعد تعليق مواد الدستور. وهذا يعكس ما يشبه “الانقلاب الناعم”، حيث يُقدَّم إقصاء البرلمان كمقدمة للتنمية، وتُختزل الدولة في يد الحاكم. فهل يكون الإصلاح هنا مجرد واجهة لتكريس السلطة، لا أداة لتوزيعها؟
تحويل الأزمة إلى سردية رسمية
استخدمت السلطة أزمة العلاقة بين الحكومة والمجلس كذريعة لإعلان الخطة. لكن بدلًا من إصلاح النظام السياسي لإعادة التوازن، تم تفكيكه. وهكذا تحولت الأزمة إلى سردية رسمية تبرر الاستثناء، وتُشيطن الماضي، وتمنح الأمير احتكار المستقبل. وهي سردية خطرة لأنها لا تسمح بمراجعة أو نقد أو حتى مشاركة.
“خطة الأمير” تفتقر إلى مقومات المشروع الإصلاحي الحقيقي: الشرعية، الشفافية، والمشاركة. وهي –بصيغتها الحالية– تُقارب منطق الإصلاح السلطوي لا الديمقراطي، وتُعيد إنتاج أزمة الدولة من موقع أعلى. وإذا لم تتم العودة إلى الدستور كمصدر للشرعية، فإن كل خطة، مهما كانت عناوينها براقة، لن تكون إلا غطاء لانقلاب ناعم على الدولة الدستورية.