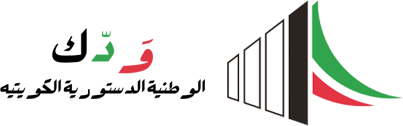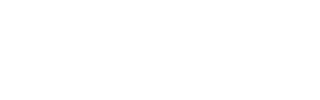منذ نشأة الكويت الحديثة، كانت العلاقة بين الحاكم والمجتمع تقوم على نوع من التفاعل المتوتر ولكن المستمر: المجلس يضغط، والسلطة تستوعب أو تتصدى، والمجتمع يراقب ويشارك ويحتج. غير أن ما حصل في 10 مايو 2024 لا يمثّل فقط لحظة تعليق للدستور، بل تحولًا جذريًا في فلسفة الحكم: من دولة تتعامل مع مجتمع، إلى سلطة تتصرف كأن المجتمع غير موجود أو لا يملك حق الشراكة.
تآكل مفهوم “المواطنة السياسية”
في النظام الدستوري، يُفترض بالمواطن أن يكون طرفًا في إنتاج القرار العام، عبر صوته الانتخابي، ومشاركته في النقاش، وضغطه على ممثليه. أما في الوضع الحالي، فقد تم تفريغ المواطن من صفته السياسية، وتحويله إلى مجرد مُتلقي للتوجيهات أو مُصفق للقرارات. لم يعد المواطن شريكًا، بل متفرجًا مع وقف التنفيذ.
تغييب المجتمع لصالح الإدارة
السلطة اليوم لا تخاطب المجتمع، بل تديره كما تُدار الشركات: بالكفاءة، والانضباط، والتنظيم من الأعلى. تم استبدال السياسة بالإدارة، والنقاش العام بالتقارير الفنية، ووجع الناس بمؤشرات اقتصادية. وهذا المنطق يُقصي الشعب لا بالبطش، بل بالإهمال المنهجي، حيث لا يُرى المجتمع إلا ككتلة تحتاج إلى “إصلاح”، لا كقوة قادرة على أن تُصلح السلطة ذاتها.
الإعلام والتربية كأدوات للتمرير
رافقت هذه التحولات هندسة خطاب عام جديد، يُشيطن السياسة ويُعلي من “الهدوء”، ويُقدّس الإنجاز الفني ويحتقر الجدل الدستوري. وبهذا، تم تحويل المواطنين إلى جمهور مُعاق سياسيًا، لا يملك أدوات الفهم ولا التغيير، بل فقط واجب الثقة والطاعة. التعليم، والإعلام، وحتى الثقافة، باتت كلها أدوات لإنتاج هذا النمط من “اللا-مواطنة”.
لا يمكن بناء دولة حديثة بلا مجتمع حي، ولا يمكن تحقيق إصلاح من دون مواطن فاعل. وبعد عام من تعليق الدستور، تتضح ملامح مشروع يطمح إلى حكم بلا سياسة، وسلطة بلا مساءلة، وشعب بلا صوت. لكن المجتمعات لا تُلغى، بل تؤجل، ولا تُقصى، بل تُراكم الغضب والحنين معًا. وكل إقصاء مؤقت، هو مشروع أزمة دائمة.